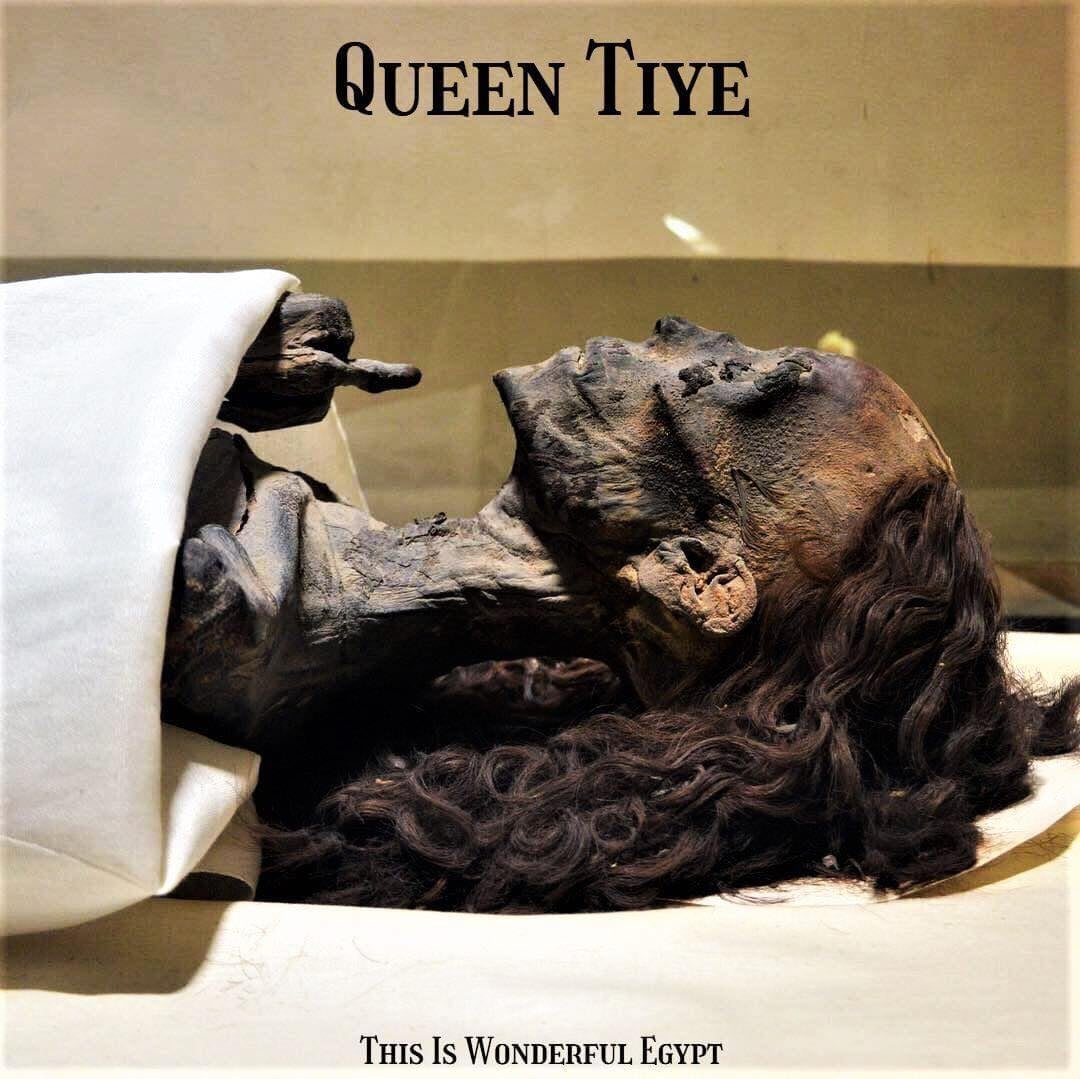إلى من يهمه الأمر.. تدريس النصوص الأدبية بين الجمال والقُبْح


إن النفس الإنسانية تحب الجمال وتَأْنَسُ به وتسعى إليه، والكلمة المبدَعة فيها نوع من أنواعه، فكم راقتنا جملٌ، وسمعنا صداها، ليس فقط بأسماعنا، ولكن بقلوبنا وأحاسيسنا، وتيقناها ورددناها دون عنت أو مشقة، فجمال الكلمة سر من أسرار انجذابنا نحوها، ومضاد الجمال القبح، الذي تشمئز منه النفوس، وتثقل به الأفئدة، وتصم عند سماعه الآذان، فـ((إنَّ من البيان لسحرًا))، وما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان.
وإذا تحققنا من تلك العاطفة التي تحرِّكُنا نحو جماليات الكلمة، فذلك يلعب دورًا حاسمًا في نشر اللغة، عندما نختار لها اللوحة الجميلة في شكل كلمات متراصة جذابة، ويعلو حلاوة اللفظ إبداع المعنى، وأداء غرض من أغراض الحياة الإنسانية الراقية، فذلك يسهم بشكل كبير في جنوحنا نحو اختيار ذلك المثال من اللغة الراقية العذبة.
لقد ظللنا فترة من الزمان نلاحق فكريًّا بعقول تقليدية، نحاكي الماضي من منظور ضيق، وليتنا كنا نعيه قدر ما يحتويه من كنوز وعبقريات تسبق الهمم، وإنما قلدنا فيه جمود أفكارنا ومشاعرنا في احتفاظنا بصورة واحدة لا تتغير ولا تتجدد مع العصور والأزمنة، وهذا قد بَعَث بداخلنا الملل والفتور، فهابك تجلس مستمعًا إلى نغمة واحدة أو لحن واحد من الألحان، ثم ظَلَلْتَ عليه قائمًا، دون تغيير، وتُورِثُ مَنْ جاء بعدك ذلك اللحن أو تلك النغمة، أما ترى أنك تَمَلُّ ويَمَلُّ غيرُك من تكراره مدة من الزمان، وكذا الأمر لتلك الصورة التي تعلقها في حجرة ضيوفك، أما ترى أنك مع الزمن والأيام قد ينتابك منها جفاء، فلا تحرِّك فيك ساكنًا، ولا ترى إلا شيئًا فاترًا، لا ينبئ عن قيمة ولا خيال ولا جديد من الذوق.
إن روح المفاجأة بالجمال هي التي تعكس القيمة والندرة، والمفاجأة هي بعينها الجديد والخروج عن الأنماط التقليدية التي تهواها النفس البشرية.
وإذا جاز لي أن أقص ما رأيته في عهدي مع التعليم عندما كنت طالبًا، وعندما صرت معلمًا، فإننا في نهاية الثمانينيات درسنا في الثانوية العامة جمعًا من النصوص الأدبية المختارة لبعض شعرائنا قدامى ومحدثين، ولقد تعجبت كثيرًا عندما وجدت المحتوى بعينه من الآداب هو ذاته الذي يدرس إلى يوم قريب من يومنا هذا، أي بعد مرور سنوات طويلة، لا أقول إنهم قد اختاروا نصًّا جديدًا للشاعر نفسه، وإنما داوموا على اختيار النص بعينه، لقد نظروا إلى ما يقدمون على أنه ليس رأيًّا أو جمالا، ينبغي أن يختلف باختلاف السياق الاجتماعي والثقافي والذوقي للدارس، ولكنه مثل النظرية العلمية التي تدرس من خلالها الآداب وتاريخها، فالتزم الجفاء والجفاف في كلماته وأوزانه، حتى صار خارجًا عن تلك المفاجأة التي ترغب فيها النفس ويلذ بها السمع، فإن الأدب يرتبط بتجارب مبدعيه وكذا متلقيه، التي لا تخلو من عاطفة تساند الفكرة، ومع تكرارها وإعادتها بشكل تقليدي تتفرغ من شحنتها العاطفية، فتنقص عنصرًا مهمًّا من مكونات الأدب، وهي المفاجأة التي تُحْدِثُ التذوق والعذوبة، ولقد كانت لي تجربة في التدريس في جامعة الوصل بدبي، وكان المسار متجهًا نحو اختيار النصوص المرتبطة بحياة الطالب، والمعبرة عن هويته وثقافته وتقاليده، مما انعكس مردوده على مستوى التحصيل وإيجاد الذات، مع الأخذ بالتطوير المستمر وتحديث المحتوى العلمي، مما أسهم في نقلة علمية كبيرة.
والأمل في التخلص من تلك المناهج التقليدية في دراسة الآداب، بوصفها نموذجًا ومحاكاة لنظرية علمية، وليس بوصفه إبداعًا بالكلمة المحملة بطاقات تخرج أحيانًا عن حدود الملامسة بالدرس ونظرياته وملاحظاته وقوانينه، فتفقد حياتها الفنية تدريجيًّا خاصة عند الذين يقومون بتدريسها للطلاب؛ لأنهم أكثر الناس تكرارًا لها، فإذا تسرب الملل إليهم، وهو طبيعي ومتوقعٌ، فإنه ينتقل إلى من يتلقونه من أبنائنا.
فإننا في حاجة إلى ثورة من التغيير في مناهجنا التي تعنى بتدريس الأدب، وإخراجها من الرتابة والمداومة على نماذج بعينها، فنختار الشعر الجيد المناسب لروح العصر، المعبر عن أحلامنا وطبيعتنا البشرية، وليس شرطًا أن يكون إبداعًا لشعرائنا المعاصرين، فهناك من الشعراء المجيدين في الزمن القديم من طالتنا أشعارهم بحلاوتها وجمالها، بل ربما تكون أصدق تعبيرًا عنا مما نؤلفه نحن، فتبدو إشكالية تدريس الآداب في انتقاء النماذج والأمثلة، وليس فقط في ارتباطها بزمن دون آخر.
وبمعنى آخر نريد النصوص الأدبية التي تقيم فينا الإحساس بالجمال وتؤسس روح العاطفة في بناء مشروع قومي، يقوم على أساس أن تكون اللغة تتصف بالقومية، وتلك هي اللغة القومية التي لا تقتصر على مجرد التفاهم، ولكنها تصوغ أعماق الإنسان، وترسخ صور الموجودات.


 جامعة أسيوط تحيل بطل واقعة ”بن شرقي” للتحقيق
جامعة أسيوط تحيل بطل واقعة ”بن شرقي” للتحقيق صقور المكافحة تداهم دواليب المخدرات في 5 محافظات
صقور المكافحة تداهم دواليب المخدرات في 5 محافظات وزيرة الهجرة تفتح مشروعًا لإحياء الحرف التراثية بالجمالية أسسه مصري بكندا
وزيرة الهجرة تفتح مشروعًا لإحياء الحرف التراثية بالجمالية أسسه مصري بكندا غدا ..وزيرة الهجرة تفتتح مشروع ”إحياء الحرف القديمة ” بحى الجمالية
غدا ..وزيرة الهجرة تفتتح مشروع ”إحياء الحرف القديمة ” بحى الجمالية أمن القاهرة يضبط عصابة للتنقيب عن الآثار
أمن القاهرة يضبط عصابة للتنقيب عن الآثار أمن القاهرة يضبط عصابة للتنقيب عن الأثار
أمن القاهرة يضبط عصابة للتنقيب عن الأثار حصريًا: الكينج يتحدث لـ”محطة مصر” عن حالته الصحية ويعلن موعد طرح ثالث أغاني ”باب الجمال”
حصريًا: الكينج يتحدث لـ”محطة مصر” عن حالته الصحية ويعلن موعد طرح ثالث أغاني ”باب الجمال” في ذكرى وفاته.. رأفت الهجان مشوار من الأزمات والمطبات
في ذكرى وفاته.. رأفت الهجان مشوار من الأزمات والمطبات ملحن” باب الجمال” يتعاون لأول مرة مع محمد عدوية
ملحن” باب الجمال” يتعاون لأول مرة مع محمد عدوية هاجر أحمد بطلة مسلسل ”ضربة معلم”...من مسابقات ملكات الجمال إلى التمثيل
هاجر أحمد بطلة مسلسل ”ضربة معلم”...من مسابقات ملكات الجمال إلى التمثيل محمد منير يستعد لطرح ”باب الجمال”
محمد منير يستعد لطرح ”باب الجمال”